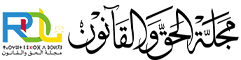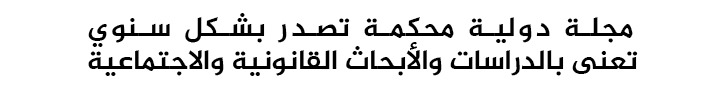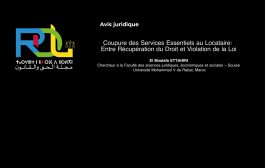المفوض القضائي وكتابة الضبط
بين سلطة التنفيذ وسلطة التوثيق في ضوء القانون 46.21
ياسيــن كحلـي
مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

في دولة تتجه نحو تأصيل مبدأ الجودة داخل المرفق القضائي، لا يمكن لمهنة المفوض القضائي أن تبقى حبيسة النظرة التنفيذية الصرفة، ولا لهيئة كتابة الضبط أن تظل مجرد ذراع إداري للتوثيق. إن القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين جاء ليعيد ترتيب العلاقات الدقيقة داخل هندسة العدالة، وعلى رأسها العلاقة بين المفوض القضائي وكتابة الضبط، لا باعتبارها مسألة تنظيمية عابرة، بل كحجر زاوية في تأمين شرعية المساطر وتنفيذ الأحكام وفقا للضوابط القانونية. فالوظيفتان، وإن تباعدتا شكليا، إلا أنهما تشتبكان ميدانيا، ويجمع بينهما سجل من التنسيق والإلزام والمساءلة المشتركة.
انطلاقا من ذلك؛ أفتح النقاش حول أوجه هذا التداخل، مستندا إلى مواد القانون الجديد، ومناقشا فلسفة المشرع في هذا التقاطع الذي يعكس عمق التحول داخل المنظومة القضائية المغربيــة.
إن القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين لم يكتف بتحديد وظائف المفوض القضائي، بل رسم الإطار الحاكم لعلاقته بمختلف الأجهزة المكونة لمنظومة العدالة، وعلى رأسها كتابة الضبط، بوصفها الجهاز الإداري الحي داخل المحكمة. وقد تجلت هذه العناية في عدة مواد صريحة من القانون المذكور، أبرزها ما ورد في المادة 17 التي خولت لرئيس كتابة الضبط صلاحية مسك سجل خاص يتضمن أسماء المفوضين القضائيين المعينين في دائرة المحكمة الابتدائية، مع بيانات دقيقة تتعلق ببدء مزاولة مهامهم، عناوين مكاتبهم، أرقام هواتفهم، نماذج توقيعاتهم، وأسماء الكتاب المحلفين العاملين لديهم. إننا أمام سجل مهني لا يراد به فقط حفظ البيانات، بل التأسيس لسلطة إشراف مادي تمكن من مراقبة الأداء اليومي وربط المسؤولية بالتوثيق.
هذا التوثيق يجد امتداده في المادة 18 التي تفرض على رئيس المحكمة ورئيس المجلس الجهوي (للمفوضين القضائيين) مسك ملف خاص بكل مفوض، تودع فيه التقارير، العقوبات، والوثائق المهنية، مما يجعل من كتابة الضبط الحاضنة الإدارية للمسار المهني للمفوض، وهي وظيفة تتطلب دقة وحزما. ولا تقتصر العلاقة على الجانب التوثيقي فقط، بل تتوسع لتشمل الميدان الإجرائي المباشر، كما في المادة 49 من الباب الخامس الموسوم بــ “مهام المفوض القضائي وإجراءاته”، حيث يلزم المشرع كتابة الضبط بتسليم الطيات والاستدعاءات والوثائق التنفيذية إلى المفوض القضائي بواسطة سجل تداول خاص، ويلزم هذا الأخير بإرجاع شهادات التسليم قبل الجلسات بثلاثة أيام على الأقل. لا يتعلق الأمر هنا بإجراء إداري بحت، بل بضمان جوهري لحق التقاضي، إذ يترتب على هذا الإرجاع انتظام الجلسات وضمان مبدأ المواجهـة.
ولا يغيب الجانب الرقابي عن هذا التفاعل، حيث تتمظهر كتابة الضبط، من خلال المادة 37 من نفس القانون، كجهة مؤتمنة على قانونية السجلات التي يمسكها المفوض، فهي التي تؤشر وتوقع وتراقب، ما يحولها إلى ضامن قانوني لإثبات صحة الإجراءات. ولعل من أهم ما يكرس هذه المكانة، ما نصت عليه المادة 21 التي تحمل رئيس كتابة الضبط مسؤولية الشهادة على صفاء الذمة الإجرائية للمفوض القضائي حين يرغب في الانتقال، عبر التأكيد على تصفية الملفات وتسليم الوثائق والسجلات، أي أننا أمام شهادة إدارية ذات أثر قانوني مباشر على المركز المهني للمفوض.
إن هذه العلاقة القائمة على الترابط المؤسسي تجد ترجمتها كذلك في حالات التوقف أو الوفاة أو الإعفاء، كما في المواد من 22 إلى 27، حيث تظل كتابة الضبط طرفا رئيسيا في حفظ محاضر الحصر والإحصاء، ما يؤكد أن المفوض القضائي لا يعمل في فراغ مهني، وإنما ضمن شبكة قضائية وإدارية تتداخل فيها المسؤوليات، ويضبط فيها كل انتقــال أو توقف بموجب مستند محرر ومحفوظ في أجهزة المحكمة.
لعل ما يكشفه التنظيم القانوني الجديد من تفاصيل دقيقة حول العلاقة بين المفوض القضائي وهيئة كتابة الضبط، ليس مجرد تصحيح لوضع سابق، بل هو تعبير عن وعي مؤسسي بأن العدالة لا تنجح بسلطة القاضي وحده، بل بتكامل أدوار من يهيئ الأرضية لما يحكم به. وبين سلطة التنفيـذ التي يحملها المفوض، وسلطة التوثيق التي تمارسها كتابة الضبط، تنشأ ضمانة الإجراء القانوني المشروع، وتبنى ثقة المتقاضي في أن مآل دعواه لن يختزل في حكم معلق، بل في مسار مكتمل يربط النص بالفعل، والحق بالمسطرة. في التفاصيل التنظيمية الدقيقة التي رسمها القانون رقم 46.21، لا نقرأ فقط قواعد مهنية، بل ملامح عدالة حديثة تعيد ترتيب علاقاتها الداخلية على أساس من التنسيق والرقابة المتبادلة، دون انتقاص من استقلالية أي طرف، ولا تجاوز لاختصاصه، وهذا هو جوهر الإصلاح الحقيقـي.